في ذكرى أوسلو المشئومة، إعادة نشر رؤية الجبهة منها
08 أغسطس 2018
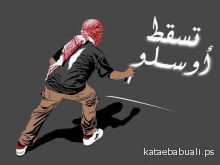
[JUSTIFY]يصادف اليوم ذكرى اتفاقية أوسلو المشئومة، التي وقعتها القيادة المتنفذة في منظمة التحرير الفلسطينية، مع دولة الاحتلال الصهيوني في 13 سبتمبر 1993، وسمي الاتفاق نسبة إلى مدينة أوسلو النرويجية التي تمت فيها المحادثات السرّية التي تمت في عام 1991 أفرزت هذا الاتفاق في ما عرف بمؤتمر مدريد. تعتبر اتفاقية أوسلو سيئة الصيت والسمعة، التي تم توقيعها في 13 سبتمبر/ أيلول 1993، أول اتفاقية رسمية مباشرة بين دولة الكيان الصهيوني ممثلة بوزير خارجيتها آنذاك المجرم شمعون بيريز، وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثلة بأمين سر اللجنة التنفيذية محمود عباس. ورغم أن التفاوض بشأن الاتفاقية تم في أوسلو، إلا أن التوقيع تم في واشنطن، بحضور الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون. وفي هذا اليوم المشئوم، يعيد المكتب الإعلامي نشر رؤية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حول هذه الاتفاقية المشئومة، من خلال " الرؤية السياسية" الصادرة عن مؤتمرها الوطني السادس والذي عُقد عام 2000: هل أوسلو سلام أم إعادة إنتاج للصراع بأشكال متجددة؟ ليس مطلوباً منا الآن إعادة النقاش في المخاطر والأضرار الجسيمة المتراكمة التي لحقت بالقضية الفلسطينية، جراء اتفاق أوسلو وما تلاه، لأن ما ورد في الوثيقة السياسية الصادرة عن الكونفرنس الوطني الأول عام 1994، بالإضافة إلى ما تناولته وثائق الجبهة الشعبية الصادرة عن هيئاتها الأولى بهذا الصدد وغيرها، أكثر من كاف. إن ما نود تناوله الآن، يتخطى هذا الجانب، ويستهدف تعميق رؤيتنا وتحليلنا، استناداً للمعطيات والمستجدات التي شهدتها السنوات القليلة الماضية. إن اتفاق أوسلو وما تلاه من اتفاقيات، وما حمله وجسده من مخاطر، ليس أكثر من مرحلة عابرة مؤقتة في الصراع قد تطول أو تقصر، دون أن يعني ذلك التقليل من ثقل الأضرار والمصاعب التي حملتها تلك الاتفاقيات، أو الاستخفاف بها وكأنها لم تكن. على العكس من ذلك، فإننا ننطلق من إعادة التأكيد على حقيقة أنها تشكل مرحلة نوعية في الصراع، اندثرت فيها عناصر ومكونات وأساليب وبنى ونماذج، ودخلت إليها أو في طريقها إلى التكون والتبلور، عناصر ومكونات وأساليب وبنى ونماذج جديدة. [انهيار الاتحاد السوفييتي، وتغيير لوحة التحالفات الدولية هيمنة الولايات المتحدة التغيرات التي شهدها الواقع العربي منذ حرب الخليج الثانية قيام السلطة الفلسطينية تغير موازين القوى الداخلية أزمة القوى الديمقراطية ظاهرة التطبيع ومقاومته...]. إن الانتقال من مرحلة إلى أخرى، ليس بتلك البساطة التي يتخيلها البعض، إنها تشبه عملية المخاض، بما يرافقها من آلام ونزف وتحولات معنوية ونفسية. ولكنها تعني في النهاية الولادة وبدء دورة جديدة للحياة بكل نواظمها وعناصرها. بناءً عليه، فإن المرحلة الراهنة وبمقدار ما تحمله من عمليات قطع مع المراحل السابقة، فإنها تبقى مرتبطة معها بألف حبل سري تفعل فعلها وتلقي بأثقالها وظلالها على الواقع. لقد ألقت القيادة الفلسطينية المتنفذة، بعد حرب الخليج الثانية وانهيار الاتحاد السوفييتي، بمعظم أوراق القضية الفلسطينية وأهمها في خانة الرهان على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى ما يزعمه الكيان الصهيوني من استعداد للسلام. تنبع خطورة هذه السياسة، وما ترتب عليها من خيارات عملية واتفاقات محددة، من أنها لا تقوم على رؤية سليمة وعلمية لطبيعة الصراع وجذوره، وتعبر عن فهم مذعور وسطحي لموازين القوى القائمة، ولطبيعة المشروع الأمريكي الإسرائيلي للسلم وأهدافه الاستراتيجية. لقد استجابت لمقتضيات الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية، وسمحت لديناميات تلك الاستراتيجية بأن تتحكم بها وبخياراتها، مما افقدها بالتدريج، وبصورة متتابعة غير عنصر من عناصر القوة المادية والتاريخية والشرعية التي كانت تتمتع بها، وباتت تبعاً لذلك تنطلق في ممارستها السياسية، وكأن ما يجري هو الخيار الوحيد المتاح أمامها أو باعتباره نهاية المطاف للصراع العربي الصهيوني، وفي القلب منه الصراع الفلسطيني الصهيوني. هذه السياسة البائسة في فهم الصراع وإدارته مع العدو، هي الوجه الأخر لسياسة بائسة أخرى تجاه الداخل الفلسطيني، والتي تجلت في ذهنية قاصرة، تراكمت تاريخياً لتأخذ شكل بيروقراطية عاجزة ومدمرة، سلاحها الإفساد، وهو ما قاد إلى تبديد كثير من مكونات القوة الفلسطينية، وأدى إلى عدم امتلاك رؤية شاملة وبعيدة النظر لتعزيز البنية الداخلية للمجتمع الفلسطيني في مختلف مواقع انتشاره، من خلال تعزيز البنى التنظيمية والمؤسساتية والإدارية ... لهذا المجتمع. أبرز نموذج على ذلك هو، عملية تحطيم وتمزيق أهم إطار وطني فلسطيني في الفترة المعاصرة أي م.ت.ف . حيث جرى التعامل معها بصورة محزنة ومؤلمة. إن دل ذلك على شيء فإنما يدل على قصر نظر السياسة التي مورست، وخفة التعامل مع هذا الإطار الهام، الذي كان من المفروض أن يبقى بمثابة الإطار الوطني الجامع، والمعبر الحقيقي عن وحدة الشعب الفلسطيني المشتت والممزق جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً. يضاف لما تقدم، عدم القدرة أو الرغبة في استثمار الطاقات والكفاءات الوطنية لصالح تعزيز البنية الاجتماعية وتقوية ركائز المجابهة الوطنية، وهو الأمر الذي عبر عن نفسه باستمرار سياسة الهيمنة والتفرد، وإغراق مؤسسات المجتمع الفلسطيني في الوطن المحتل في دوامة الفساد، وعدم احترام الإنسان وحقوق المواطن، هكذا وجد المواطن الفلسطيني نفسه بين فكي كماشة: الاحتلال بممارساته القمعية والتوسعية في جانب، وممارسات السلطة وأجهزتها في جانب آخر. هذا الأمر فاقم المأزق الذي تعيشه الجماهير الفلسطينية، والقضية الوطنية في الوطن المحتل وفي الشتات. ترافق الواقع المشار له، مع ممارسة لا تقل خطورة وقصر نظر، تمثلت في النظرة الاستخدامية للحركة الشعبية الفلسطينية، مما أدى إلى توسيع المسافة بينها وبين السلطة السياسية، وبالتالي فقدان الثقة بالسلطة التي لم تحافظ على الحد الأدنى من الحقوق الوطنية وحمايتها، وفي الوقت نفسه لم تدل ممارساتها تجاه المجتمع الفلسطيني، ولوعلى حد أدنى من الاحترام والثقة، تجلت تلك السياسة وأخذت ثلاثة أشكال أساسية هي : أ- الملاحقة والاعتقال نزولاً عند إملاءات الاحتلال. ب- الانتهازية والاستخدام اللحظي المؤقت للحركة الشعبية. ج- محاولة تكييف المعارضة مع سقف السلطة وسياساتها. قادت هذه السياسة إلى نتائج خطيرة على الحركة الوطنية الفلسطينية، ذلك أنها ساهمت في تعزيز حالة التمزق والافتراق، وإبقاء أسباب الاستنزاف والانفجارات الداخلية قائمة. كما أفرغت سياسة السلطة، مفهوم الحوار الوطني من مضامينه وركائزه، وبالتالي حولت مسالة الوحدة الوطنية، إلى ورقة مناورة، وليس خطاً سياسياً ناظماً لفعل الحركة الوطنية الفلسطينية بتلاوينها وتياراتها وتنظيماتها المختلفة. إن الذهنية السياسية والفكرية التي قادت إلى الرهان المتسرع والقاصر على المشروع الأمريكي الإسرائيلي للسلام، هي الذهنية نفسها التي أفضت إلى حالة الرضوخ بهذه الصورة الدرامية، مستغلة حالة الإنهاك والإعياء التي أصابت الشعب الفلسطيني والأمة العربية نتيجة ضغط الحلف المعادي وديناميات القصور الداخلي، التي تسببت بها أصلاً تلك الذهنية التي أتقنت كيفية تبديد الموارد أكثر مما عرفت كيف تراكمها. لقد دفع العدو، ومنذ مدريد، بكل الهزائم العربية المتراكمة إلى المسرح السياسي، حين ارتأى أنه آن الأوان لكي يخطو خطوة انعطافية هامة، تتمثل بضرورة فرض الهزيمة سياسياً، وتشريعها رسمياً وقانونياً على الصعيدين العربي والدولي. وهكذا تم الانتقال من مستوى الحرب المباشرة إلى مستوى الحرب غير المباشرة، التي تتكئ إلى ميزان قوى شامل مختل لصالح الحلف الأمريكي الإسرائيلي. إن ما جرى في مدريد وما تلاه من محطات واتفاقات وتجاذبات، لم يخرج عن إطار عملية الاقتحام السياسي التي تديرها الولايات المتحدة بتنسيق كامل مع الكيان الصهيوني. وبالتالي فإن المشروع السياسي- الأمريكي للتسوية كما جرى تظهيره في أوسلو لا يخرج عن كونه مشروعاً لفرض مزيدً من الرضوخ السياسي والاقتصادي على المنطقة، والذي بلغ حدوداً غير مقبولة مع الحد الأدنى من الشعور بالكرامة. يفسر لنا ما تقدم حقيقة الدور الأمريكي، الذي بعد أن أدخل الأطراف المختلفة في دينامية التفاوض، على أساس مبادئ عامة تراعي ولو جزئياً بعض قرارات الشرعية الدولية، انتقل بعدها إلى ممارسة شتى صنوف الضغط والإرهاب لفرض الرؤية الإسرائيلية للتسوية التي تتناغم في الجوهر والرؤية الأمريكية. وبكلمة أخرى، فرض الاستسلام على العرب وليس إنجاز عملية سلام كما يقال نفاقاً، وذلك من ضمن منطق يجد ما يبرره في فلسفة القوة كأساس لإدارة العلاقات الدولية. فلسفة ملخصها : حق للمنتصر فرض شروطه على المهزوم. إن هذا دون غيره، هو الذي يفسر انحياز السياسة الأمريكية بصورة فاضحة ومتواصلة لجانب الكيان الصهيوني؟! ربما، آن الأوان للكف عن سذاجة من نوع الاعتقاد بأن الإدارة الأمريكية بكل ما تملك من معلومات وخبرة في إدارة الصراعات الدولية، لا تدرك أن الحديث عن السلام في الشرق الأوسط يبقى محض هراء وخداع، ما لم يتضمن الحد الأدنى من الحقوق الوطنية الفلسطينية والحقوق القومية العربية. إن الإدارة الأمريكية تدرك هذه الحقيقة أكثر من غيرها وليس هنالك من يستطيع، حتى الدفاع عن أكذوبة، أن الولايات المتحدة تريد فعلاً الوصول لسلام ضمن القواعد التي تقرها أبسط قواعد ومواد القانون الدولي ومفاهيم الحرية والعدالة والتوازن؟! وليس من فلسفة القوة لفرض ما يناسب مصالحها. بناء على ما تقدم، لا تعود المشكلة في هذه الحكومة أو تلك كما يحاول البعض أن يروج. إن المشكلة تكمن بالأساس في طبيعة المشروع الأمريكي الإسرائيلي للسلام الذي هو في الحقيقة ومن ناحية المنطق والهدف مشروع واحد. لولا ذلك، لقامت الولايات المتحدة بتقديم نص دقيق وواضح لمشروعها السياسي الخاص للسلام في الشرق الأوسط، ويكون جزءً من تعديل شامل يجعل سياستها مراعية للحد الأدنى من العدالة والتوازن واحترام الحقوق المشروعة. لولا أن الولايات المتحدة ما زالت على سياستها المعادية، لكفت عن اللغة العائمة والغامضة، عند الحديث عن السلام، ولتوقفت عن ممارسة أوسع ضغط معنوي ومادي ممكن على الأطراف العربية، بينما تواصل تزويد الكيان الصهيوني بكل مكونات القوة، وتؤكد ليل نهار بأنها ستبقى ملتزمة باستمرار بتفوقه النوعي على الدول العربية مجتمعة، إضافة إلى تشكيل مظلة سياسية لممارساته، سواء في المؤسسة الدولية، أو على صعيد إقامة الأحلاف العسكرية والأمنية المعادية السري منها والعلني والذي بدأ يلتف حول جغرافية الأمة العربية ومصالحها، إحاطة السوار بالمعصم. لقد كشفت تطورات السنوات الأخيرة، جوهر وأبعاد وأهداف وتجليات المشروع الأمريكي الإسرائيلي للسلام، والذي لا يتعدى مواصلة العمل الكثيف لتحقيق ذات الأهداف التي رافقت ولادة المشروع أي الهيمنة والإخضاع السياسي والإلحاق الاقتصادي للأمة العربية، وتصفية القضية الفلسطينية، من خلال الحرب السياسية المطعمة عند اللزوم بالعنف السياسي والاقتصادي والضغوطات العسكرية المنظمة. هذه الحقيقة التي دأبت الإدارة الأمريكية والحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على محاولة طمسها، من خلال الترويج بأن الأطراف العربية هي التي ترفض أية تسوية سلمية للصراع، كشفتها بالكامل الممارسة العسكرية للحلف الأمريكي الإسرائيلي الذي ما زال يواصل الحرب، وإن بوسائل سياسية لفرض الاستسلام على العرب وليس إنجاز سلام معهم. هذا الواقع هو الذي يقف أمام تنامي ردود الفعل العربية والفلسطينية، وانتقالها من طور الرهان إبان وبعيد مؤتمر مدريد على خيار السلام المطروح، إلى مستوى الممانعة والرفض الواسع للمشاريع الأمريكية الإسرائيلية. تكمن قيمة الممانعة والرفض المشار لهما، أنهما يتخذان طابعاً شعبياً يتسع باستمرار، ويتسمان بأنهما نتاج مبادرات شعبية، ويجذبان على نحو متزايد قطاعات واسعة من جماهير الأمة العربية إلى دائرة الفعل، وهذه ميزة لم تكن متوفرة في مراحل سابقة، حيث اتخذ الصراع بصورة رئيسية آنذاك شكل الصدام المسلح الرسمي والفدائي لاحقاً. إن الممانعة الشعبية العربية في هذه المرحلة تتسم بالشمولية والتنامي، وتقوم على رسوخ قناعة مفادها أن ما تطرحه أمريكا والكيان الصهيوني لا يتعدى محاولات إخضاع بقوة الضغط السياسي والتهديد بالحرب، لهذا نجد أنها ممانعة تتجه نحو التزايد والتأطير، وتشمل مختلف فئات وشرائح المجتمعات العربية, نذكر هنا: برفض التطبيع الثقافي، رفض الهيمنة الاقتصادية، الإصرار على مفهوم السلام الشامل الذي يلبي الحد الأدنى من الأهداف والحقوق الوطنية والقومية، وفي مقدمتها حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة وعاصمتها القدس. نجد بعض أبرز تجليات الممانعة، في الفعالية الفكرية العربية والتي تأخذ شكل الحوار والنقد، وإثارة الأسئلة الجوهرية والأساسية، ومحاولة إعادة المسائل باستمرار إلى مرجعياتها التي تعود في بعض جوانبها إلى أسباب العجز والتخلف والهزائم، وبعضها الآخر يذهب إلى إعادة اكتشاف أو التأكيد على طابع الصراع، والذي يعبر عن نفسه من خلال صراع تاريخي شامل. هذا هو الوجه الآخر الذي كشفت عنه دينامية التسوية وفق الرؤية الأمريكية الإسرائيلية، والتي لم تترك أمام المواطن العربي أو المواطن الفلسطيني سوى الاختيار بين الاستسلام المذل، وبين الاشتباك والمجابهة، وهو الأمر الذي يغذي الصراع بديناميات جديدة وبقوى دافعة جديدة بصورة متواصلة، بحيث تبدو الأمور للناظر بتفاؤل وعمق وكأن الصراع قد بدأ للتو. تقودنا الحقيقة أعلاه، إلى التأكيد بأن ما جرى حتى الآن من إزاحات سياسية تجلت في الاتفاقات الموقعة، ما هي إلا إزاحات تقوم على ذات أرضية الصراع، الأمر الذي يعني بأنها فعلاً مؤقتة وعابرة، ولن تقود إلى الأمن أو الاستقرار أو السلام. وبالتالي فأي رهان على هذه العملية إنما يعبر عن قصر نظر، أو إحباط مأساوي، أو التسليم بقضاء المشروع الأمريكي- الإسرائيلي وقدره. هذا الحديث لا يعني التقليل من خطورة ما جرى ويجري، واستطراداً، التعامل مع العملية وكأن شيئاً لم يكن. على العكس من ذلك، فما جرى خطير وثقيل الوطء، ويجب رؤيته والتعامل مع نتائجه بهدف تغييره وفق المعايير الثورية، باعتباره معطى جديد أضيف إلى لوحة الصراع. ما تقدم يفرض علينا كشعب فلسطيني وحركة وطنية فلسطينية، تعويد أنفسنا وعقولنا بأسرع وقت ممكن على التجذر والمرونة والازمة، لتلمس واستيعاب أية حركة أو مستجد في الواقع، وأن نخفف من الصخب والضجيج، ونكثف القراءة الدقيقة والفعل المستند لرؤية شاملة ومتماسكة للصراع، الذي لم يعد سراً، أنه صراع على الوجود نفسه ويدور في حيز الواقع ويدار بناء لقانون ميزان القوى [/JUSTIFY]







